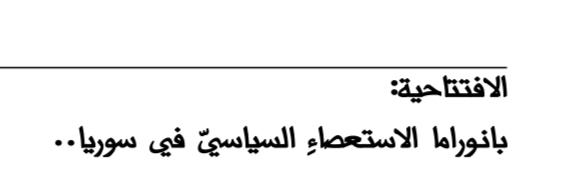بانوراما الاستعصاءِ السياسيّ في سوريا
افتتاحية العدد 15 من مجلة المشكاة الصادرة في شباط 2012
وهذا هو الدورُ المأمولُ لأي دوريّةٍ رصينةٍ. وبشكلٍ خاص في سوريا التي خرجت لفضاءِ السياسةِ بعد طولِ منع. إنه انفتاحُ فضاءِ المعنى بالمقدارِ نفسِه الذي هو انفتاحُ فضاء التفكيرِ في المعنى. وإذا كانت الثّوراتُ انقلاباً على الرّاهنِ والتبشيرِ بمجال أرحب، فإن الثقافةَ هي التفكّرُ في الاحتمالاتِ والمُمكناتِ والتّمييز بينها وبين الإراداتِ المتحوّلةِ لعاملٍ من عواملِ الموضوع. محاولةُ حياد العقلِ الذي لا يدّعي غيابَ الانحيازِ السّياسي، إنّما يعني السّعيَ المحمود للخروجِ من الموضوعِ برهةً لتأمّله. والموضوعُ هو ضوءٌ إجماليّ من مكوناتٍ لا تنفصلُ عراها في الواقعِ، تتداخلُ في تأثيرها البينيّ، وفي أحيانٍ تتشاركُ في أجزائها؛ والثّقافةُ – بأحد معانيها- مغامرةٌ لفصلِها بغية البحثِ، مع ملاحظةِ الباحثِ، ما استطاع، ترابطها مع البقية. ومن الاشتغالِ الثقافي نجد: الفكرُ السياسيّ المشغولُ بفهمِ نشأة الإراداتِ من المصالحِ، والتّعبيرات السياسيّةِ ومدى استقلالِها حينَ تدركُ ذاتها وتدركُ تفاعلَها مع باقي الإرادات. ونجدُ أيضاً الفلسفيّ المهموم بدراسةِ الكليّات والجزئيات، والتاريخي الذي ينظرُ للرّاهنِ كمحصلةٍ لما مضى ومقدّمةٍ للآتي، والاجتماعيّ الذي يبحثُ في الطبقاتِ والشرائحِ وتفاعلِ النّاس مع بعضهم.
الانتفاضةُ السوريةُ الكبرى
بعدَ اتّقادِ الثورةِ في كلٍّ من تونس ومصر وليبيا واليمن، سادَ التّرقبُ في الأوساطِ السوريّة الثقافيّةِ منها والسياسيّة والشعبيّةِ. تخوفٌ كبير أخذ يهيمنُ على الجميع بتفويتِ فرصة حراكٍ ما من المُمكنِ أن يؤدي إلى كسرِ الجمودِ الجّاثم على المجتمعِ منذ ثلاثين عاماً أو أكثر. فبدا وكأنّ التّغييرَ في سوريا يعاني من استعصاءِ البداية. التأخّرُ القصيرُ في اندلاع الثورةِ السوريةِ كان محكوماً بعواملَ خاصّةٍ بسوريا وحدها دون باقي الدولِ العربية. كانت عناصرُ هذا الاستعصاء:
– الحالةُ القمعيّة الخانقة التي يتمتّعُ بها النّظامُ السوريّ بشكلٍ يبزُّ أنداده العرب.
– التّنوع الطائفيّ والقوميّ الذي يلّونُ تضاريسَ سوريا بشكلٍ يجعلُ منه إمكانيةً قائمةً لتفكّك عرى الوطنِ فيما إذا انحرفت الثورةُ عن مسارِها.
– الدّورُ الإقليميّ الهام الذي تحتله الدّولةُ السوريّةُ في المنطقةِ وإمساكها بزمامِ ملفّاتٍ حاميةٍ في الشّرق الأوسط، مما يعرقلُ أيَّ تدخلٍ خارجيّ داعمٍ بالشّكلِ الذي حصل في باقي البلدانِ العربيّة.
– الموقعُ الجيوسياسي لسوريا، الذي وإنْ تراجعتْ أسبابُ مراعاته من قبلِ الدّول العظمى والإقليمية إلا أنّهُ لازالَ مؤثراً للدرجةِ التي تدفعُ الجميع لبعضِ التردد في سلوكهم اتجاهها.
لم تقفْ هذه العواملُ الموضوعيّةُ الكافّةُ في وجهِ الميلِ التّاريخي نحو التغييرِ في سوريا، بل لم ينتظر الوعيُ الشعبيُّ نقاشَها أو معالجتها أو حتّى التفكّر بها، التقطَ الرّوحَ المنفلتة من تونس البوعزيزي ليُغذي بها إرادةً طالما قُمعت، وأملاً بتغييرٍ يشبهُ ما حصلَ في باقي الدّولِ العربيّة، إرادةُ الشّارعِ السوري كسرت استعصاءَ البداية.
لكن حضورَ تلك العواملِ بقي حتّى الآن اللاعبَ الخفيَّ في تطوّرِ الأحداث في سوريا، فحالةُ القمعِ الشديدة التي واجه بها النّظامُ السوري الحركاتِ الاحتجاجيّةَ التي بدأت في درعا، ثم عمّت أغلبَ المناطقِ السورية، كانت عاملاً مهماً في بطءِ العمليّة التغييرية. الحالةُ القمعيّةُ المطبّقة تلك لم تُتحْ للمحتجين حجزَ ساحةٍ للحرية، ولم تتحْ توحيدَ الجهودِ بالشّكلِ الذي يبلورُ كتلةً بشريةً دائمةَ الحضورِ في مكانٍ ما، بالإضافةِ إلى أنّها ساهمت في تكريسِ التردّدِ عند قطّاعات من السوريين.
وعاملُ التّنوعِ الطائفيّ والقوميّ الذي حاولَ الشّعبُ السوريّ تجاوزَه بطرحِ شعاراتِ الوحدة الوطنيّةِ، ومقولة الشّعب السوري واحد، وجدَ نفسه أمام تحدّياتٍ منظّمةٍ من قبلِ النّظامِ وعفويةٍ ناتجةٍ كردِّ فعلٍ على النّظام، ذلك أنّ تردّدَ الأقليّات في المساهمةِ الفاعلةِ والدّخول بثقل المجموعةِ، وبروزَ الإخوان المسلمين كلاعبٍ أساسي في الحقلِ السياسيِّ، جعل السنّةَ تظهرُ باعتبارها الحاملَ الرئيس لعمليّةِ التغييرِ تلك، ولم يعفُ دخولُ كوادرٍ شبابيّةٍ مثقفةٍ وفاعلةٍ من الأقليّاتِ في المشهدِ السوريِّ من إطلاقِ هذا الحكمِ المعمّم. مضافاً إليه اللّون العلويّ الذي يصبغُ الجهازَ الأمنيّ والذي تقعُ على عاتقِه مهمةُ قمعِ الحراك، ومحاولةُ ربطِ مصير الطائفةِ العلويّة ببقاءِ النّظامِ. جعلَ شبحَ الطائفيّةِ يسيطرُ على المشهدِ السوريّ. واشتراط الكورد، القوميّة السوريّة الثانية، لتفعيلِ دورهم السياسيّ في عمليةِ التغييرِ، بوجود ضماناتٍ مطلوبةٍ من أي بديلٍ يطرحُ نفسه مقابلَ النّظام السوريّ، بددَ أملَ حضور الكورد بثقلهم السكاني في مرحلةٍ انتقاليّةٍ لا تقدّمُ ضماناتٍ سوى بالنوايا، إن وجدت! وأبرز حضور الهويّةِ الكورديّة على حسابِ هويّة سوريّةٍ مأمولةٍ.
لا يخفى على أحدٍ أن الإعلامَ وإمكانيّةَ التدخّل الخارجيّ في حلِّ النزاعات كانا من أهمِّ العواملِ التي أجّجت الشعورَ بالثّقة في إمكانيةِ التغييرِ، والذي تُرجم واقعيّاً في شعاراتٍ تبنّاها الشّارعُ السوريّ المنتفض، في طلب للحمايةِ الدوليّةِ ومناطق عازلة، وميلِ الشريحةِ الأكبر من هذا الشارع إلى المجلسِ الوطنيِّ الحامل السياسيّ المعني بشكلٍ أساسيٍّ باستمالة الخارجِ لدعم الحراكِ السوريّ ما أمكن. على حسابِ القطبِ الثاني للمعارضةِ المتمثلِ بهيئة التنسيقِ الوطنيّةِ التي عبرت عن حساسيّاتٍ لا تتفقُ بالضرورةِ مع الحراكِ الحاصل، وإن لم تكنْ دون موضوع ضمن المشهدِ الوطنيِّ العام، ما جعلها تبدو معنيّةً بإيجاد حلولٍ وسط لاعتبارها ذلك يحولُ دون الزجِّ بالمجتمعِ السوريّ باحتمالاتٍ مفتوحة. وأصبح من المعروفِ أن النّظامَ السوري ركّزَ جهودَه منذ الأيام الأولى للحراكِ على تثبيتِ فصل الداخلِ عن الخارج من خلال اعتمادِه الحلَّ الأمنيّ داخلياً، وتركيزه على مقولةِ المؤامرةِ الخارجيّة، والتلويحِ بأوراق لعبِه الأهم، وهي هنا دوره الإقليميّ الناتج عن موقعهِ الجيوسياسي و تحالفاتِه الإقليميّةِ وإمساكه بملفّاتٍ قد تثيرُ بلبلاتٍ تميدُ بمنطقةٍ لها خصوصيتها، وهي تحتوي إسرائيل وتجاور تركيا، وعدا عن كونها تشكّلُ هاجساً لعمقٍ استراتيجيٍّ لإيران؛ مضافاً إليه تركّز جزءٍ من الثروة النفطيّةِ فيها.
أما سؤالُ البديلِ فقد بقي حتى الآن بلا إجابةٍ واضحةٍ، نتيجة لضعفِ الحواملِ السياسيّةِ المجتمعية المتواجدةِ من قبل في المجتمع السوري، وعدم بروزِ حوامل داخليّة منظّمة سياسياً وذات برنامجٍ سياسيٍّ واضح المعالمِ باستثناء أقطابِ المعارضةِ الحاضرة إعلامياً أكثر من حضورِها في الواقع؛ تراخي النخبِ الثقافيّةِ والسياسية في إنتاجِ بديلٍ أصيلٍ من مكوّناتِ المجتمعِ السوريّ وممثّلٍ عنه كان نتيجةَ أمل بسقوطٍ سريعٍ للنظام ومن ثمّة إحالة إجابةِ البديل للمجتمعِ السوري ليفرزَ ممثلين حقيقيين عنه، وأيضاً نتيجةَ ضعفٍ بنيويٍّ متأتٍ من احتكارِ السياسة الداخليّةِ سابقاً.
لم يكنْ لهذه العواملِ السابقة الذكر البروز بهذه الفجاجة، لولا إنتاجُ الثورات العربيةِ لعنصر جديدٍ على المستوى السياسيِّ تمظهر بازدواجيّةِ التمثيلِ الوطنيّ. حين انتقلت بعضُ المعارضات (المثال الأوضح ليبيا وسورية) من الموقعِ المعارض بالمعنى الاصطلاحيّ إلى موقعٍ آخر أنتجته الثورةُ الشعبيّةُ انزاحت فيه المعارضةُ إلى موقعِ سلطةٍ تمثيّليةٍ أخرى للمجتمع، بالإضافة لكونها سلطةً تنافسيّةً ضمن المجتمعِ، تسعى لنزعِ الشرعيّةِ عن النظام القائمِ منطلقة من ادّعاءِ أنها هيئةٌ مخوّلةٌ من الشعبِ لتمثيله. ينتجُ عن هذا شكلان سياسيّان تمثيليان لتصبحَ العلاقةُ داخل المجتمعِ نفسِه، صوريّاً، علاقة بين دولتين متناقضتين تحتوي إحداهما الأخرى!
ساهمت سيناريوهات سقوطِ الأنظمةِ العربيّةِ في كلٍّ من تونسَ ومِصرَ وليبيا وجزئياً اليمن في تكريسِ هذه الصورةِ والإلحاحِ عليها. و التعاملُ الأمنيُّ القمعيُّ من قبل النظامِ مضافاً إليه رغبةُ الشارعِ في التغييرِ مع ثقةٍ متأتيةٍ من وحي السيناريوهات السابقة في قدرة الشارعِ السوري كما نظرائه العرب على إسقاطِ النظام، رفع سقفَ مطالبِ الشارع السوريِّ إلى إسقاطِ النظام و رفضِ ما هو دون ذلك. الأمرُ الذي أدّى إلى استعصاءِ اللغة السياسيّةِ بين جميعِ الأطراف نجده كما يلي:
في الاستعصاءِ السياسيِّ لدى النظامِ السوري
ليست الثورةُ إلا استحالةَ السياسةِ بين المجتمعِ والدّولةِ. استحالة تدفعُ فئاتٍ متزايدةً من الطرف الأولِ إلى محاولةِ كسرِ نمطِ العلاقة مع الثاني وإنتاجِ علاقات جديدة؛ باستبدالٍ قد يطال قلبَ النظامِ برمته، أو يكتفي بكسرِ القلبِ الصلبِ فيه. وليس للثورةِ توصيفٌ واحدٌ بعد المشتركِ هذا. تكون بشكلٍ رئيسٍ سياسيّةً أو اجتماعيةً أو اقتصاديّةً، أو كل ذلك مجتمعة في الوقتِ نفسِه، وبالدرجةِ ذاتِها من الأهمية. المهم في كونِها ثورةً أنها سعيٌ لتجاوزِ استعصاءٍ تسبب فيه تناقضٌ بين ما يجب أن يكونَ والقائم فعلاً بوعي هؤلاء المشاركين فيها. سوريا بهذا المعنى نموذجٌ صارخٌ لاستعصاءٍ نتجَ عن تصلّبِ نظامٍ سياسيٍّ في فترةِ شيخوختِه، فقد حيويةً بدئيّة كانت من صفاته في مرحلةِ نشأته وشبابِه، فأصبح غيرَ قادرٍ على مسايرةِ متطلباتِ الداخل والخارج.
يبرزُ هذا التصلّبُ حين النظر في علاقةِ النظام مع المجتمعِ، بل وداخل النظامِ في علاقةِ مركزه مع أطرافِه، وفي علاقتِه مع الخارج. فالزمنُ الذي كان قادراً فيه على توزيعِ المنافعِ بدائرة متّسعةٍ داخلياً معتمداً على جهاز دولةٍ رعويةٍ نشط، وكان يعتمدُ فيه على المناورةِ بين الصراعاتِ الدوليّةِ والإقليميّةِ، جاعلاً بينه وبين جميعِ الأطرافِ وشائجَ علاقةٍ وتبادل منافع، أصبح من الماضي الذي يمكنُ له التغني به دون القدرةِ على مجاراته. الانتقالُ لاقتصاد السوق، وإن تحت مسمّى السوقِ الاجتماعي، وسيطرةِ البيروقراطية المترسملة على هذا التحوّلِ وسحبِ منافعِه وإهمال خلق مخمدات لآثاره على المجتمع، ومنع شرائح الأخير من التعبير عن معاناتها وتشكيل أطرٍ مطلبيّةٍ، أنتجت حالةَ تذمّرٍ واسعة بين صفوف هؤلاء الذين فقدوا الصلةَ بالنظام وما عادوا ينظرون لمؤسّساتِه على أنها “دولتهم”.
العلاقةُ بين أطرافِ النظامِ علاقةٌ مبهمةٌ فمنذ استلامِ الرئيسِ السوري الحالي للحكمِ حاول المشتغلون بالسياسةِ الإشارةَ إلى وجودِ حرسٍ قديم وآخر جديد، وإحالة إغلاقِ الأفق السياسيِّ إلى الحرسِ القديم الذي يعودُ الآن- حسب التصنيفِ نفسِه- إلى الحضورِ بعد غياب، لإدارةِ الأزمة! يبقى الحديثُ عن هذه التشكيلةِ السياسيّةِ حديثاً يُبنى على الإشاعاتِ والتوقّعاتِ نتيجةَ سريّةِ الجهة التي تقومُ حالياً بإدارةِ الأزمة، بل حتى العقوبات التي صدرت مؤخراً وطالت شخصياتٍ سوريةً متورطةً بأعمالِ العنف عن “الهيومان رايتس” تحدثت عن هذه التشكيلةِ، ووصفتها بأنها سريّةٌ جداً وغيرُ معروفةٍ، أشارت لها باسم المخابرات العامّةِ لكن ما هو غير سري هو المعرفةُ الدقيقةُ بعدمِ إمكانيّةِ أي طرفٍ من أطرافِ النظام بالخروجِ عن الخططِ المصدرة لهم لأن المبادرةَ الفرديّةَ ضمن هذا الخطِّ قد تكونُ لمآل واحد يدعى ” الانتحار السوري”! ازديادُ تواترِ أزمةِ النظام زاد من تصلّبِه إزاء مركزيّةِ القرار ومن تشدّده في شلِّ حركةِ أطرافِه.
كما أن الضررَ اللاحقَ بمصالحِ النظام من تراجعِ دوره الإقليميِّ والامتيازات التي كان يحصلُها كنتيجةٍ لهذا الدورِ (ومنها الحذرُ من التدخّلِ بما يعتبر النظام السوري أنها شؤونه)، وسحب امتيازاتٍ عديدةً منه أبرزها نفوذه في لبنان الذي وصل حدَّ التفويضِ، دفعه للتركيزِ على علاقتِه بالجمهوريّةِ الإسلاميةِ الإيرانية على حسابِ علاقاتِه الأخرى.
العنادُ مع القوى الغربيّةِ العظمى في الخارجِ والمجتمعِ في الداخل، والخلاص إلى نظريةٍ مفادها: أن القوةَ هي معيارُ الاستمرارِ، عنى استحالة السياسة، و التموضع حيث لا يمكنُ إجراءُ تعديلٍ إلا بالقوة. وكان لهذا الوضعِ أن يستمرَّ عقوداً إن استمرت الأسبابُ الخارجيّةُ التي تكبّلُ الخصوم، لولا تعرض المنطقة لموجة تغييرٍ بعث الثقةَ بالشعوبِ بإمكانيّةِ تدخل في شؤونها. وقبل ذلك كان التورّطُ الأمريكيُّ في المستنقعِ العراقيّ، حين أصبحت القوى العظمى الوحيدة في العالمِ تبحث عن مخارجَ لمأزقها، قد أضاف المزيدُ من الثقةِ في صحة هذا التفكيرِ، فتمَّ الركونُ إلى قدرةِ القبضةِ الحديدية على حكمِ الشعب ومنعه من الحراكِ. يمكنُ القولُ دون تردّدٍ إن هذه النظريةَ أسهمت في إنتاجِ الصراعِ الحالي في سوريا وعليها، إلا أنه من التسرّعِ التوصّل إلى فشلها طالما ضمنت استمرارَ النظامِ السوريِّ ما ينيف عن عشرةِ أعوامٍ، وطالما أن الثورةَ لم تحقّقْ أهدافَها بعد. بل بتنا نشهدُ بوادرَ استعصاءٍ عند المعارضةِ، وفي الفضاءِ الإقليميِّ والدوليِّ تهدّدُ بانتقالِ الوضع السوريِّ من الثورةِ إلى الأزمة.
إن وعي النظامِ السوري بعمقِ أزمته، هو السببُ الرئيسُ لاستعصائه. فالحلُّ الأمنيُّ هو الممكنُ الوحيدُ الذي يخدمُ بقاءه بالصورةِ التي يريدُها! فاللقاءُ بين إرادةِ التغييرِ في الداخل، وبين إرادةِ الخارج بالتخلّصِ من نظامٍ أصبحت علاقتُه بإيران مصدرَ خطرٍ، تولّدت أزمةُ النظامِ السوري التي تبدو حتى الآن مستعصيةً على حلوله التي تشترطُ بقاءه على حاله. فلا هو قادرٌ على إجراءِ تسويةٍ خارجيّةٍ تعني نهايةَ علاقته بإيران، الأمرُ الذي يكشفه على القوى الداخليّةِ دون حليفٍ خارجيٍّ، ونعلمُ أن الغربَ ليس محلَّ ثقةٍ عنده تحديداً وهو يراه يتخلّى عن أقربِ حلفائه في مصرَ وتونس، ولا هو قادرٌ على إجراءِ تسويّةٍ داخلية ستفضي بعد حين لتغييره عبر صناديقِ الاقتراعِ وستؤدي مباشرة لكسرِ احتكارِه الحياة السياسيةَ الداخليّةَ والخارجيّة مما يعني ضغطاً من القوى الداخليّةِ بملفاتٍ عدة منها تحالفُه مع إيران. وبما أن الانفتاحَ حصل بين الداخلِ والخارجِ أصبح من المستحيلِ إجراءُ تسويةٍ مع أيٍّ منهما دون الآخر لذا أصبحت التسويةُ مستحيلةً. والاستحالةُ هي السببُ الذي يجعلُ من كلِّ المناوراتِ السياسيّةِ للنظامِ تراكماً للفشلِ وتكثف الاستعصاء.
في استعصاءِ المعارضةِ
عند الحديثِ عن نظامٍ استبداديٍّ شموليٍّ، يصبح من المفهومِ أنّ الظروف الاستثنائيّةُ التي تعيشُها المعارضةُ تمنعُ عنها التحقّقَ بصيغة تيارٍ شعبيٍّ وازن. لولا ذلك لما كان من استبدادٍ ولا شموليّةٍ؛ فتحقّقُ النظامِ الشموليّ هو بالقضاءِ على المعارضةِ، وحصرها بحدودٍ مجهرية. وخلال أربعين عاماً من احتكارِ السلطة الاستبداديّةِ للفضاء العام، وتحويلِ أي معارضة لجريمةٍ تصلُ حدَّ التخوين، وجد المعارضون أنفسَهم بين خياري النفي الإجباريّ و الطوعيّ، أو التأقلم مع الوضعِ الراهنِ الذي يصلُ إلى تبنّي جزءٍ من مقولاتِ النظامِ والتعبيرِ عن شيءٍ من إرادته. ساعد هؤلاء الذين اختاروا الاحتمال الأخير المشتركات التأسيسية عند الطرفين بغيابِ الإخوان المسلمين الذين تمَّ “اجتثاثُهم” من الحياةِ في سوريا. وأيضاً تكرار تعبيرات ومقولات النظام المعادية للخارج كتقنيّةٍ سياسيةٍ أدمن المعارضون عليها إلا أن شيئاً منها هو وليدُ فضاءٍ ثقافيٍّ سياسيّ سوري كفر الخارج وقرر المطابقةَ بين الانفصالِ عنه ومقولة السيادةِ الوطنية.
منذ ربيعِ دمشق عام 2004 برزت محاولاتٌ لتجاوزِ هذا الوضع، من خلال الانشقاقِ عن النظام بإيديولوجيته المتضمّنةِ صورته عن نفسِه وعن العالم. عنى ذلك بناءَ صورةٍ أخرى توازي تلك وتعارضها، وتدّعي صحتَها. ومع انطلاقِ فاعلياتِ الانتفاضة السوريّةِ الحالية برزت نتائجُ هذا المسعى حين التقى قسم من مثقفي المعارضةِ مع الحراكِ وأسهموا في بناءِ صورةِ هذه الانتفاضةِ التي قُدِّمت للعالمِ وعرَّف المشاركون بها عن أنفسِهم. لكن هذا اللقاءَ لم يعنِ التقاءَ الحراك مع ما تبين أنه معارضاتٌ ثلاث: واحدةٌ أقربُ للنظامِ من نفسه، ترتبطُ معه مصلحياً وتتطرّفُ عنه في العداءِ مع الخارج والتخوّفِ من أن يمتلكَ الناسُ استقلاليتهم؛ وأخرى أعلنت الانشقاقَ عنه، تطالبُه بالتغييرِ الديمقراطيّ وتتشاركُ معه ببعضِ الهواجس، وأبرزُها تلك الخاصّة بالأقليّات؛ وثالثة كانت طوال الوقتِ نقيضُه، ونتيجةَ وجودِها خارج البلد(والسجون قد تكون الخارج في عمقِ الداخل) أسّست بالتوازي مع أُطروحاتِه تفنيداً لكلِّ خطابِه وأفكاره. وأسّست مصدراً من مصادرِ الوعي العام للحراكِ الشعبيِّ الراهن عبر نجاحِ المثقفين في إنشاءِ “معارضة ثقافية”.
بدا الحراكُ منفصلٌ عن المعارضاتِ ودعاها فيما بعد للتوحّدِ على البرنامجِ الذي أقرّه بنفسِه بالتفاعل مع القمعِ الذي يتعرّضُ له. برنامجٌ يبدو للوهلة الأولى أنه متناسبٌ مع المعارضةِ القصوية، ولكن عند التدقيقِ يظهرُ كم هي عاجزةٌ عن القيامِ بدورِها المأمولِ منه. فإذا كانت المعارضةُ “الوسطيّة” فقدت روابطَها بإرادةِ الناس، وأعلنت عن قناعتِها بوجودِ فرقٍ بين ما يطالبُ به الناسُ وبين “الممكنِ” الذي لا يعلمُ بخوافيه إلا أهلُ الاختصاص، فإن المعارضةَ الأقصويّةَ تبنّت مطالبَ الشارعِ دون إضافةٍ، ودون قدرةٍ على خلقِ دليلِ عملٍ يراكمُ على الأرض ويطوّرُ السلطةَ البديلةَ التي صنعها الحراكُ وأعطاهم الثقةَ للنطقِ باسمها. وهو إذا ما نظرنا له في سياقِ استطالةِ الزمنِ وتعقّد المهمات لا يتركُ مجالاً للطمأنينةِ على قدرةِ هذه المعارضة على الاحتفاظِ بتمثيل الناسِ وقيادتِهم. طالما أنها لم تمتلك القدرةَ الكافيةَ للتفاعلِ مع المتغيرات التي تحملُ من ضمن ما تحمل امكانيةَ تجاوزهم وتقديمِ حلولٍ عملية للتطوّرِ المطلوب. بالإضافة إلى أنها لم تبدِ براعةً في اللعبِ السياسيِّ الخارجيّ، ذلك أن غياب عاملَ احتكار السياسةِ الخارجيّةِ من قبل النظامِ السوريِّ عن الساحة الثقافية والفكرية ( وهو الذي نراه العاملَ الأبرزَ في قدرةِ النظامِ على مواجهةِ الغربِ وتصوّراته للمنطقةِ) والتركيز على احتكار السياسة الداخلية، وغيابِ التعامل الجديِّ مع هذا الموضوع من قبل القوى المعارضة بما يقتضيه من تعاملٍ براغماتيٍّ دقيقٍ ومنظمٍ ومعرفة بالخصمِ وطريقةِ تفكيرِه وانتهاج أساليب تمسّ التكنيك السياسيَّ والقبض على المعادلةِ العامّةِ ثم الخوض في تفاصيلِها.مما سيغلبُ احتمالَ أن يزدادَ استقلال الحراك عن المعارضةِ، وأن يعودَ لمحاولةِ المأسسة التي بدأت فيها لجانُ التنسيقِ المحليةِ حينما نشأ عن نشاطِها تنسيقيّاتٌ تخصصيّةٌ أبرزها “تنسيقيّةُ الأطباء”.
هي ثلاث رؤى معارضة عن الواقعِ والحلولِ المطلوبة، يتحدّدُ صوابية أي منها برجحانِ احتمالٍ من الاحتمالات خارجها. أن ينجحَ النظامُ بتخطّي الحراك وإجراءِ إصلاحاتٍ شكلية سيقوي “معارضةً” معاديةً للحراك، تخشاه أكثر مما تخشى النظامَ. أو أن يفشلَ النظامُ وتقرر أطرافٌ فيه إجراءَ تسويةٍ كبيرة وستجدُ نفسَها حينها بحاجة لمعارضةٍ تفاوضها وتقاسمُها السلطةَ، وهو ما سيجعلُ من دور لهيئة التنسيقِ الوطنية. أو تُحسَمُ التردّدات الدوليّةُ ويُتوَّجُ التقاءُ الداخل مع الخارج بخطواتٍ دراماتيكية لإسقاطِ النظام، الأمرُ الذي يفعلُ دور المجلس الوطني. وتفشلُ كلُّها مجتمعةً إن دخلت الحالةُ السوريّةُ نفقَ الأزمةِ المستديمة، حينها لا يصبحُ هناك حاجةٌ لها فالحراكُ سيطوّرُ بناه التمثيلية المستقلّةَ، وينتجُ معارضةً تشبهه. يتبدّى استعصاءُ المعارضةِ الراهنة بكونها لم تستطع الانتقالَ من خارج الموضوعِ إلى داخله، منع من ذلك: انفصالُها سابقُ الذكرِ عن المجتمع الذي جعلَ لها ذهنيّةً متعاليةً قليلةَ الصبر على متطلّباتِ التواصلِ والحوار مع الناسِ بتنوّعِهم المعرفيّ والمطلبيّ؛ تمحورُها حول التنافسِ على السلطةِ بتغييبٍ للسياسة وضروراتها مشابهٌ لما لدى النظامِ الذي تنافسه، فنجدُها تميلُ للاستئثار فاقدةً للقدرةِ على التحالفِ والمشاركةِ؛ فقدانُها لرؤيةٍ تنظيميّة تنقلُ الحراكَ لمستوى أعلى تنظيميّاً، وتساعدُه على تملّكِ سلطة بديلةٍ أكثر فاعلية.
الخارجُ و إدارةُ الأزمةِ
الطرفُ الثالثُ في الاستعصاء السوري هو الخارجُ الدوليّ، القوى الغربيّة العظمى، والإقليميّة، تركيا وما اصطُلِح على تسميته “محور الاعتدال” وإيران مدعومةً من روسيا والصين. الدولُ الغربية من موقعِها لم تعد تحتملُ تصلّبَ النظامِ وانتقال تحالفه مع إيران إلى مرحلةٍ اعتبرت أنه تمَّ احتواؤه منها. الصراعُ مع إيران هو مركزُ الصراعِ في المنطقة. لا يعني هذا أن الغربَ كان ليكونَ راضياً عن علاقته بالنظامِ السوريِّ بوضعه الراهنِ، وهو ما يراه من بقايا الحربِ الباردةِ، لولا صراعُه المحتدمُ مع إيران، ما نعنيه هو أن الصراعَ المركزيَّ يرخي سماتَه على امتداداتِه، ويحدّدُ حجمَ العدائيّةِ. ونتيجةً لتعاظمِ النفوذ الإيراني، تحديداً مع انسحابِ الاحتلالِ الأمريكيّ من العراق، وإمكانيّةِ امتلاكها سلاحاً نووياً ينقلُها إلى مصاف الدولِ الإقليمية العظمى ما يجعلُ تهديدَها على محيطها النفطيِّ شديدَ الوطأة، يستمدُّ النظامُ السوريُّ جلَّ قوته الراهنة، ويجعله حلقةً في تحالفٍ إقليميٍّ معادٍ للغرب ولبقيةِ محيطه. ومن بين كلِّ ما يمكنُ أن يتناقضَ مع الدولِ الغربية يمكنُ عدُّ هذه القضية الأساسيّة التي لا يمكنُ لهم تجاوزها.
فالولاياتُ المتّحدةُ والاتحادُ الأوربيُّ المأزومان اقتصادياً يستشعران خطرَ النموِّ الاقتصاديِّ الصينيّ ودول العالمِ الثاني من البرازيل والهند وإيران وروسيا، ويقلقان من نجاحِها في توسيعِ مساحة نفوذِها وقدرتها على التأثيرِ. بالإضافةِ إلى خطّةٍ اقتصاديّةٍ تسعى لوضع خريطةٍ جديدة للمنطقةِ تضمن مرور الغاز المسيّل مصدر الطاقة البديل عن النفطِ بأمان ودون مساوماتٍ، الأمرُ الذي سيساهمُ في درء أخطار الركودِ الاقتصاديِّ ويعيد إنتاجَ معادلةِ السيطرة على الطّاقةِ البديلة.
لذا ولغيره أدى الغربُ دورَ الداعم لموجةِ التغيير العربي، بقليلٍ من الاهتمامِ لما تريدُه شعوبُ المنطقة. الموجة التي عنت لهم أشياءَ مختلفةً في كل بلدٍ من البلدان التي اجتاحتها:
– في تونس رفعُ كفاءة النظامِ وقدرته على التطوّرِ بالتوازي مع متطلّباتِ النموِّ، وتوزيع أفضل للثروةِ يسمحُ بإعادة إنتاجِ حياة قابلةٍ للعيش وتفريغ مكامنِ التطرّفِ الدينيّ والسياسيّ.
– في مصر تحريرُ النظام هناك من التزاماتِ الرئيسِ المخلوع حسني مبارك وبطانته، وإنهاءُ حالة الاحتكارِ السياسيّ والاقتصاديّ الذي أدى لتعميمِ حالة البؤسِ وفقدان مصر دورها الإقليميّ القائد المؤهل لمواجهةِ النفوذِ الإيراني.
– في ليبيا ترشيدُ الحكمِ حتى يأخذَ بعين الاعتبارِ بعضاً من مطالبِ الداخل ويتحوّلَ لداعمٍ إضافيٍّ للدور المصريِّ وتحويلها لمكمنِ استقرار نفطيٍّ في ظلِّ توقع احتدام الصراعِ مع إيران وتأثير ذلك على محيطِها النفطيّ. ووضعُ يدِهم على خطّةٍ لإعادة الإعمار كانت في نهايةِ المطاف بقيمة 680 مليار دولار!
– في سوريا إخراجُها من التحالفِ مع إيران وانتقالِها لصفِّ النظام العربيِّ المهدّد إيرانياً.
بخصوص سوريا لا يوجدُ لدى الدولِ الغربيّةِ وصفةٌ معتمدةٌ للوصول للهدف. يمكنها استيعابُ احتمالاتٍ لا نهائيّة؛ منها أن تكونَ سوريا موقع اشتباكٍ طالما أنها تدركُ استعصاءً بنيويّاً في النظامِ تمنعُه من إجراءِ تسويةٍ داخليّةٍ توحّدُ الداخلَ في مواجهة تحدّياتِ الصراع الإقليميِّ المحتدم. وفعلاً استطاع النظامُ القيامَ بما يتمناه خصومُه حين فوّتَ الفرصةَ التي لاحت بتشكيلِ هيئةِ التنسيقِ الوطنيّةِ لعدم قدرتِه على تصوّرِ مستقبلِ شراكةٍ في الحكمِ مع الآخرين وإجراء التعديلات اللازمة لحصولِ ذلك. ووجدت الولاياتُ المتّحدةُ أنها غيرُ مضطرّةٍ للتحرك أكثر طالما أنه يدفعُ الصراعَ الداخليَّ للانفتاحِ على الخارج. وهو ما يعني حتى لحظةِ كتابة هذا النصِّ أن الولاياتِ المتّحدةَ تجدُ فائدتها في إدارةِ الأزمة السوريّةِ، وتنظرُ بعين العطفِ للاندفاعِ الذي يقوم به خصومُها باتجاه مأزقِ الصراعِ السنّيِّ الشيعيّ.
خاتمة
من الاستعصاءِ الداخلي السوري الذي سبّبَه تعنّتُ النظامِ واختياره الحلَّ الأمنيّ وفشله فيه، وعدم قدرة الحراكِ الشعبيِّ حتى هذه اللحظةِ على تغيير موازين القوى بحيث تسقط النظام، وهو الهدفُ الذي حدّدَه لنفسه، وفشل المعارضةِ في تحقيق نقلةٍ داخلية من خلال مأسسة الحراك؛ ما يتيحُ فتحَ آفاقِ صراعٍ استنزافيّ للنظام لغيابِ أيّ برنامج أو رؤية بهذا الخصوص عندها، ولدمويّةِ النظام – فتح الداخل على الخارج بشكلٍ غير مسبوق؛ حيث أصبحت سوريا ملفَّ أزمةٍ في الجامعة العربية، وموضوعاً للتفاوضِ بين دول إقليميّةٍ، وكذلك دوليّة، وفي كثيرٍ من الأحيان بغيابِ ممثلين عنها من النظام أو المعارضة. التجاءُ النظام لإيران وفّرَ له دعماً ماديّاً وسياسيّاً حاسماً لم يكن ليستمرّ دونه، ومدّه بخبراءَ في مجالاتٍ عدّة، وجيّشَ له كل تحالفاتِه. ولكن في الوقتِ نفسِه جعل لها وصايةً ستدفع سوريا كلفة كبيرة لاحقاً .(في حال استمرارِ النظام). من جانبٍ آخر وجدَ المجلسُ الوطنيُّ نفسه، وهو ممثّلُ الحراك الشعبي، أمام طريقٍ وحيدٍ هو المطالبةُ بالتدويلِ والحمايةُ الدوليّة نتيجة الاستعصاءِ الداخليّ ونزيف الدم السوريّ، ما يهدّدُ بمزيدٍ من التورط في التجاذباتِ الإقليميّةِ والدوليّةِ. تحديداً أن النظام السوري سبقَ وفتح الباب للتدخل الخارجي، بما فيه العسكري، لإيران وإلى حد ما روسيا.
وهكذا يبدو جلياً أن هناك تداخلاً بين مصالحِ أطراف عدة تشكّلُ المشهدَ الإجماليّ. وإذا كان النظامُ، الذي ثار الناسُ عليه لتصلّبِه واحتكاره للمجالات كلِّها من سلطةٍ وثروة وتعبيرٍ سياسيٍّ ولتفشّي الفساد الشامل الذي صنعَه، يركّزُ على خصوماته الخارجيّة معلّلاً ثورةَ الشعب السوريِّ بها جاعلاً من طلبِ الحريةِ مؤامرة يستوجبُ سحقَها فإن اختصارَ الداخلِ وحركته العظيمة بطلبِ التدخّلِ الخارجيّ يبطلُ المبادرةَ الشعبيّةَ التي استطاعت التجدّدَ على الرغم من قسوةٍ غيرِ مسبوقةٍ يتعرّضُ لها الحراك. ونجد أن في السعي العفويِّ للناس للتجمّعِ والتضامنِ والتكافلِ، وإنشائهم بنى عملٍ مشتركة، ونموذجها الأبرز لجان التنسيق المحلية التي أظهرت وعياً مدنيّاً متقدّماً حين بادرت إلى محاولاتٍ أوليّةٍ لمأسسة الحراكِ، مؤشر للممكناتِ العظيمةِ الكامنة في أحشاءِ المجتمعِ المتحرك؛ الأمرُ الذي يبشّرُ بأننا أمامَ عصر جديدٍ لسوريا، يبني فيه أبناؤهم مشاركتَهم السياسيّةَ الفاعلة رغماً عن قوى القهرِ. ونستنتجُ أيضاً أن هناك عناصرَ للاستعصاء ترخي بظلالِها على الانتفاضةِ، وتهدّدُ جديّاً إن استطاعت استبدالَ إرادة المنتفضين بإرادتِها على كسرِ إرادتهم أو تحويلِها لوقودِ معركتها، ولكن حتى لحظة كتابة هذه المقدمة يبدي الشعبُ المنتفضُ وعياً عفوياً متسارعاً في تسييسه، يستعيضُ عن غياب دولةٍ وطنيّةٍ (أجهضها النظامُ) بالحرصِ الشديد على إعادةِ خلقِ هذه العناصر.
سيكون من المهمِّ للباحثين التمييز بينَ المجتمعاتِ التي تملكُ في مكوناتها عواملَ التّفتت وتلك التي تتحد بفعل اجتماع عناصر الوحدة فيها. ونجد أنَّ المجتمعَ السوري الذي استطاعَ الحفاظ على وحدتِه حتّى الآن، وقاوم زجّه في آتونِ حربٍ أهلية، بالرّغم من تعرضِه لأوسعَ عملية تفتيتٍ من المُمكن أن تجري عليه من قبل نظامٍ سياسيٍ لا يتوانى عن الإدّعاءِ بأنّه هو ضامنُ الوحدة الوطنيّة وحاميها- لجدير بأن يكون نموذجاً بهذا المعنى. وإذا أضفنا إلى ذلك فرز المجتمع لآليّاتِ العملِ الجماعي من خلالِ الفئاتِ المدنيةِ، وأبرزها لجان التنسيق المحلية التي صمدت أمامَ سيلٍ من الحملاتِ الموجهةِ ضدها بالتحديد، لأدركنا بعضاً من أسبابِ قناعتنا بأنّ إرادة التغيير السوريّة منتصرةٌ في مواجهةِ أسبابِ الاستعصاءِ مجتمعة.
يجتهدُ كتاب عددنا، الذي بين أيديكم، في البحثِ والتدقيقِ في عناصرِ الواقع السوري، فأنتجوا باجتهادِهم مقارباتٍ طموحةً للنجاح في المعادلةِ الصعبة: النظرُ في الموضوعِ من خارجه دون افتقادِ حسّ الواقع. يصعبُ من المهمة آنيةِ الحدث وعنفه المنفلت، ولكن المأمولَ يبقى أن يكونَ المنهجُ جزءاً من الإضافةِ التي نقدّمُها بغضِّ النظر عن الاتفاقِ أو الخلافِ مع نتائج المشاركين. المشكاةُ مشروعٌ طموحٌ بهذا المعنى تحديداً: إسهامٌ في إطلاقِ روحِ النقد الحرّة، والتعرّف على مناهجِه وأساليبه. وما بين أيدينا هو خطوةٌ في طريقٍ وعر وطويل، يسهّلُه علينا أيّ فائدة يجدُها القارئُ في طيّاتِ المجلةِ.
للاطلاع على الافتتاحية في العدد اضغط هنا أو أدناه
[gview file=”https://drsc-sy.org/wp-content/uploads/2019/04/MESHK15-مضغوط.pdf”]